البابا ثيوفيلس الأول
البطريرك الثالث والعشرون
في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري
(385-412م)
ينتمي البابا ثاوفيلس إلى الجيل الثاني الذي تتلمذ للقديس أثناسيوس الرسولي، باعتبار أن البابا بطرس الثاني البطريرك الـ 21 وخليفته البابا تيموثاوس البطريرك الـ 22 ينتميان إلى الجيل الأول.
طفولة البابا ثاوفيلس:
يُرجح أنه من مواليد عام 350م تقريباً. ويمدنا المؤرخ الأسقف يوحنا النقيوسي المعاصر لدخول العرب إلى مصر، في مؤلّفه التاريخي، بتفاصيل عن طفولة أنبا ثاوفيلس لم تذكرها المصادر التاريخية الأخرى. فقد وُلد في “ممفيس” أعرق المدن الفرعونية القديمة وبالتالي، فقد تشبعت عيناه وذاكرته بمناظر الهياكل والمعابد الوثنية ومواكب واحتفالات 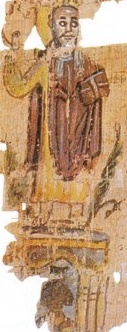 العبادات القديمة، كما عايش في طفولته عائلات الكهنة وخدام هذه الهياكل التي كانت الدولة لا زالت تتكفل بالإنفاق عليهم من الأراضي والإقطاعيات الموقوفة على هذه الهياكل. فالدولة حتى ذلك الوقت كانت ملتزمة بمرسوم قسطنطين الكبير بالتسامح الديني والحرية العقيدية كخطوة أولى خرجت بعدها الكنيسة من الكهوف والسراديب المظلمة إلى سطح الحياة اليومية في العالم.
العبادات القديمة، كما عايش في طفولته عائلات الكهنة وخدام هذه الهياكل التي كانت الدولة لا زالت تتكفل بالإنفاق عليهم من الأراضي والإقطاعيات الموقوفة على هذه الهياكل. فالدولة حتى ذلك الوقت كانت ملتزمة بمرسوم قسطنطين الكبير بالتسامح الديني والحرية العقيدية كخطوة أولى خرجت بعدها الكنيسة من الكهوف والسراديب المظلمة إلى سطح الحياة اليومية في العالم.
وقد توفي والداه في طفولته تاركين له أختاً أصغر منه. وقد تولت جارية حبشية تربيتهما، مما يدل على أن ثاوفيلس كان من أسرة ثرية. وربما خشيت هذه المربية على الطفلين من البقاء في المدينة الوثنية، لذلك رحلت بهما عام 356م إلى الإسكندرية ودخلت بهما إلى كنيسة العذراء التي بناها القديس ثاؤنا بطريرك الإسكندرية الـ 16، حيث كان القديس أثناسيوس – آنئذ – يُصلّي فيها. وبعد انتهاء الصلاة عرف القديس أثناسيوس من الجارية الحبشية قصة الغلامين اليتيمين الذين برفقتها، فأبقاهما عنده وتربيا في الكنيسة. فلما كبرا، تزوجت الابنة في المحلة الكبرى، ولدت ابناً سنة 375م، صار فيما بعد البابا كيرلس عامود الدين. أما ثاوفيلس، فانضم إلى سكرتارية البابا أثناسيوس، أي أنه درس في المدرسة اللاهوتية وتتلمذ لمعلميها وعاصر آخر عظمائها العلامة ديديموس الضرير، كما أتاح له الوجود في السكرتارية معاينة تطور العلاقات بين الإسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية.
بطريركيته
من أهم الإيجابيات التي حفظها التاريخ لهذا البطريرك رغبته الحارة لبناء وتعمير الكنائس، ومقاومته للعبادة الوثنية. وقد ساعده على ذلك ما عاينه في طفولته التي قضاها في ممفيس من مباذل العبادات الوثنية، فأضمرت فيه بغضة تلقائية تجاهها.
ومن جانب آخر، كان وجود إمبراطور قوي وهو ثيودوسيوس الكبير، الذي تبنى سياسة حكيمة لربط طرفي محور الحكم في إمبراطوريته الدولة والكنيسة سبباً في تمتع الشعوب بالأمن والاستقرار. كما أن التأييد الشعبي لهذه السياسة جعلها تنجح في أقصر وقت. فالكراهية الشعبية ضد الوثنية المنحطة سهلت عليه إصدار أول مرسوم بإعلان المسيحية ديناً رسمياً للدولة. وهذا يعني سحب كل الرواتب والأوقاف التي تتكفل بها الدولة تجاه المعابد والهياكل الوثنية، وبالتالي تجاه كهنتها وخدامها. والخطوة التالية الحتمية هي احتضان الدولة للكنيسة والوقوف معها ضد البدع والهرطقات التي تشتت رعيتها.
ومن هنا برزت كنيسة الإسكندرية لتتصدر كنائس الشرق المسيحي، وكذلك برزت شخصية أنبا ثاوفيلس ليقوم بدور هام سواء في الكنيسة أو في الدولة.
فأولى المهام التي أُلقيت على عاتق البابا ثاوفيلس سنة 388م، كانت إعادة تنظيم حسابات أعياد الفصح، حيث بلغ الفارق بين كنيسة روما غرباً، وكنيسة الإسكندرية وباقي الكنائس التي تدور في فلكها شرقاً؛ خمسة أسابيع وصار البابا ثاوفيلس صاحب القاعدة التي ما زالت سارية حتى الآن، وهي: أن يكون عيد الفصح في الأحد التالي لعيد الفصح اليهودي وهو اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العبري – وقت اكتمال القمر عقب الاعتدال الربيعي – وإذا وافق الرابع عشر من نيسان يوم أحد، يؤجل الاحتفال بالفصح للأحد التالي لئلا يكون احتفال المؤمنين واليهود في يوم واحد. وقد وضع أنبا ثاوفيلس الجداول الفصحية لمدة مائة سنة تالية.
البابا ثاوفيلس بنَّاء حكيم:
لم ينس البابا ثاوفيلس – بلا شك ما رآه أثناء سكرتاريته للبابا أثناسيوس، وما عاناه شعب الإسكندرية أثناء الصلاة في كنيسة لم يتم تشييدها بعد، بسبب ضيق أماكن العبادة. لذلك كان غيوراً نشيطاً في هذا المضمار.
وفيما يلي نُقدِّم سرداً لبعض أعمال هذا البطريرك، ليس على سبيل الحصر، ولكن ما أمكن العثور عليه في مختلف المصادر والترجمات التي تحدثت عنه :
1. كنيسة القديس أول الشهداء : يقول السنكسار القبطي الذي نشره المستشرق الفرنسي رينيه باسيه في سيرة القديسة أكساني تحت يوم 29 طوبة، أنها كانت أرملة غنية من روما، وجاءت إلى الإسكندرية مع ابنيها. فلما سمعت عن رغبة البابا ثاوفيلس في تنظيف المنطقة الأثرية المعروفة حالياً باسم “كوم الدكة لاستغلالها في بناء الكنائس؛ قدَّمت أموالها للبطريرك، فاستخدمها لتنظيف المكان وبناء كنيسة على اسم القديس ، وألحق بها ديراً للعذارى والمكرسات قضت فيه هذه السيدة الكريمة بقية حياتها. وصارت قديسة معروفة في الكنيسة، كما رسم ابنيها أسقفين.
2. أثناء عملية التنظيف، عُثر على كنز يرجع إلى عصر الإسكندر الأكبر، وعليه ثلاثة حروف ثيطا اليونانية. وفسرها المعاصرون أنها تشير إلى الله ، وثيئودوسيوس الإمبراطور، وثاوفيلس البطريرك وابتدأ البابا ثاوفيلس في تحويل معبد باكوس إلى كنيسة.
3. ويذكر السنكسار أيضاً أن يوم 3 نسئ هو تذكار بناء بيعة على اسم الملاك روفائيل” في الإسكندرية أيام البطريرك ثاوفيلس.
4. وتقليد دير المحرق الحالي، يقول إن الذي أنشأه هو أنبا ثاوفيلس.
5. كما بدأ أيضاً في بناء كنيسة مار مينا بصحراء مريوط، واكتمل بناء الكنيسة في عهد أنبا تيموثاوس الثاني البطريرك الـ 26.
6. وجاء في مخطوطات دير أنبا مقار أن هذا البطريرك قد أوفد بعثة من رهبان شيهيت تحت قيادة أنبا يوحنا القصير إلى بابل لإحضار أجساد الثلاثة الفتية القديسين الذين ألقاهم نبوخذ نصر في أتون النار؛ حيث إن البطريرك قد أقام لهم كنيسة تذكاراً لهم. وبعد وصول البعثة إلى مكان دفن الثلاثة الفتية، ظهروا لهم ليلاً طالبين ألا يفصلوهم عن دانيال النبي المدفون إلى جوارهم هناك، ووعدوا أنهم سيحضرون أثناء تكريس كنيستهم في الإسكندرية. وتحكي المخطوطة أن الثلاثة الفتية ظهروا أثناء التكريس في الكنيسة التي أقيمت في بيت الشهيد أباقير، وخصص لهم البابا ثاوفيلس عيداً يوم 10 بشنس كتذكار لهذا الظهور.
تحويل المعابد الوثنية إلى كنائس
تكشف شخصية البابا ثاوفيلس، وخليفته البابا كيرلس عن مدى توثق العلاقات بين الكنيسة والدولة. فنجاح الدولة في تجميع الشعوب المتفرقة حول عقيدة صحيحة واحدة، وسع من سلطان الكنيسة ودخولها في مجالات لم تطرقها من قبل.
وقد استثمر البابا ثاوفيلس هذا التعاون في الاستفادة بكل المعابد الوثنية المهجورة لتحويلها إلى كنائس. ويُقال إن الإمبراطور سلم له مفاتيح هذه المعابد من الإسكندرية إلى أسوان. وكان أشهرها في الشرق الأوسط هو معبد السرابيوم في الإسكندرية، الذي حوله إلى كنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان وأليشع النبي اللذين أحضر الرهبان رفاتهما منذ أيام القديس أثناسي الذي لم تسنح له الفرصة لبناء كنيسة لهما. وحقق البابا ثاوفيلس رغبة معلمه ببنائها، واستمـ محتفظة بالرفات حتى القرن العاشر.
أما معبد السرابيوم فقد أقيم في عهد ملوك البطالمة، لما نجح علماء الديانتين الفرعونية واليونانية في تخليق عبادة جديدة تجمع الشعبين المصري واليوناني هذه العبادة الجديدة كان يمثلها العجل أبيس المصري وأوزيريس الإله الفرعوني الذي أخذ صبغة إغريقية نتيجة تزاوج المصريين واليونانيين. ويجسم هذه العبادة كهل جالس على كرسي هو الإله سيرابيس، ممسكاً بيده اليمنى صولجاناً، ويضع اليسرى على كلب ذي ثلاثة رؤوس يمثل الإله الحارس على عالم الأموات في العبادة اليونانية.
وبسبب سرعة انتشار عبادة سيرابيس تطور تمثاله إلى جسم إنساني ضخم تمتد يداه من المحرس الداخلي المعتم (قدس الأقداس أو الناووس) إلى الطرف الآخر . ثم دخلت إليه عناصر فارسية من عبادة مثرا، وهي عبارة عن تقديم ذبائح بشرية دموية.
وكان من الطقوس الأساسية التي تجري في السرابيوم، أنه عند بدء فيضان النيل تؤخذ كمية من مياهه وتقدم للإله سيرابيس لكي يُبارك الفيضان الذي يغمر مصر بالخيرات. لذلك كان يوجد فيه مقياس للنيل. على أنه في عصر الإمبراطور قسطنطين الكبير طلب منع هذا الاحتفال، وأرسل للبابا ألكسندروس البطريرك الـ 19 أن تُقدَّم المياه في الكنيسة وليس في المعبد الوثني. لذلك نقل مقياس النيل إلى كنيسة القيصاريون كنيسة حي القصور الملكية (كامب شيزار حالياً). ومن هذا الوقت دخلت أوشية المياه إلى الليتورجيا المصرية.
وهكذا تحولت العبادة الوثنية في هذا المعبد إلى عبادة الله الحي، وشيدت في نفس المكان كاتدرائية عظيمة وُضِعَ فيها رفات يوحنا المعمدان وأليشع النبي وصارت فيما بعد مدفناً لبطاركة وأساقفة الكنيسة. وقد تثبت يوم 2 بؤونة الموافق 9 يونية عيداً لتكريس هذه الكاتدرائية.
أعماله الأدبية:
الإنتاج الأدبي للبابا ثاوفيلس يشهد أنه كان كاتباً كنسياً قديراً، وللأسف لم يتبق منه سوى القليل. وما نذكره هنا هو البعض من هذا القليل:
1- الجداول الفصحية وقد سبق الإشارة إليها سابقاً في سيرته، وما نعرفه عنها هو مقدمتها باللاتينية.
2- مراسلاته وهي كم ضخم ترجم العلامة جيروم بعضها إلى اللاتينية ضمن مجموعة رسائله. فالرسالة 92 هي رسالة مجمعية أرسلها أنبا ثاوفيلس في سبتمبر عام 400م إلى القديس إبيفانيوس أسقف قبرص ضمن رسائل أخرى إلى أساقفة مصر وفلسطين يعرفهم بقرارات المجمع المحلي الذي انعقد في الإسكندرية ضد المعجبين بأوريجانوس ومبادئه. وقد أرسل رسالتين للعلامة جيروم نفسه في صيف عام 400 م يحرّضه في الأولى ضد الأوريجانيين، والثانية للتعريف بالأب الراهب ثيئودورس الذي كان في طريقه إلى روما وآخر هذه المجموعة كانت رسالة للقديس إبيفانيوس يوصيه فيها بعقد مجمع لتحريم الأوريجانية، ويقترح أيضاً على رؤساء أساقفة آسيا الصغرى السير في نفس هذه الخطوات.
وهناك أيضاً مجموعة رسائل متبادلة بينه وبين أورسيزيوس ورهبان الأديرة الباخومية في فابو (قرية فاو حالياً) محفوظة في ترجمتها القبطية من القرن السادس / السابع، نشرها عالم القبطيات الألمانيCrum كروم
ويذكر سقراط في تاريخه الكنسي أن البابا ثاوفيلس أرسل خطابين إلى إمبراطوري الدولة الرومانية ثيودوسيوس ومكسيموس عام 388م، على يد الأب إيسيذورس، ورسائل أخرى كتبها حوالي عام ٣٩٥م وذلك في أعقاب الخلاف الذي نشب بين العلامة جيروم ورفيقه روفينوس، يُظهر فيها تعاطفه مع روفينوس. وفي عام 390م أرسل خطاباً إلى أنبا يوحنا بطريرك أورشليم يعرفه أنه قد قبل اعتذاره عن اتهاماته ضد العلامة جيروم. وبعد فترة وجيزة كتب إليه بخصوص رسامة أخيه باولينوس فرد عليه العلامة جيروم في رسالتيه رقم 82،63. وفي عام 402م تراسل مع القديس يوحنا ذهبي الفم بخصوص “الإخوة الطوال، وهي القضية التي سنتناولها بعد قليل.
كما توجد أيضاً إشارات وتلميحات في أعمال أدبية أخرى تفيد مراسلاته مع باباوات روما أنستاسيوس عام 399/ 400 م ، وإنوسنت الأول في يوليو عام 404م ؛ ومع البطريرك فلابيانوس الأنطاكي عام ٤٠١م وخليفته بورفيريوس عام 404م.
3- رسائل فصحية خلال بطريركيته التي امتدت حوالي 28عاماً، كان أنبا ثاوفيلس مواظباً على تقليد كرسي الإسكندرية. ومعروف من رسائله الفصحية 26 رسالة على الأقل. فالرسائل التي صدرت أعوام 404،402،401 حفظها القديس جيروم في ترجمة لاتينية، ويظهر فيها اتجاه أنبا ثاوفيلس المناهض للأوريجانية. كما أن التاريخ لا يزال يحفظ نصوصاً من رسالتين أخريين تزخران بالمضمون اللاهوتي الغني في لغتهما اليونانية الأصلية مع ترجمة قبطية أيضاً.
ولا نعرف عن بقية رسائله الفصحية سوى شذرات متفرقة في أعمال أخرى، مثل: الطبوغرافيا المسيحية للرحالة قزمان إنديكوبلوستس Cosma Indicopleustes وفي ردّ البابا تيموثاوس الثاني بطريرك الإسكندرية الـ 26 على عقيدة الخلقيدونيين، وفي كتابات يوحنا كاسيان، وسينسيوس أسقف الخمس المدن الغربية، وجناديوس المؤرخ اللاتيني، وفي بستان الرهبان، وغيرها.
4- مواعظه ما نعرفه منها :
+ عن الدينونة محفوظة باليونانية في الأبوفثجماتا باترم؛ ونُشرت ترجمتها السريانية عام 1913م.
+ عن التعفف والندامة؛ وقد نشرها عالم القبطيات كروم Crum عن بردية في المتحف البريطاني.
+ عن الصليب واللص؛ نُشرت بالقبطية في تورينو بإيطاليا.
+ عن الإفخارستيا وكانت منسوبة للقديس كيرلس الكبير في الباترولوجيا اليونانية، وأعاد تصحيح نسبتها إلى أنبا ثاوفيلس العالم الفرنسي Richard الذي تخصص في الأعمال الأدبية للأنبا ثاوفيلس.
+ وتوجد مقالة على رؤيا اشعياء النبي 6: 1-7 كانت محفوظة تحت اسم العلامة جيروم. لكن الدراسات الحديثة رجحت نسبتها للبابا ثاوفيلس. ولا يزال الكثير من أعماله الأدبية في القبطية والحبشية لم تتم دراستها أو نشرها حتى الآن.
مؤلفاته المنحولة (أي المنسوبة إليه):
هناك أعمال أدبية نُسبت خطأ إلى أنبا ثاوفيلس؛ أهمها ما نشره المستشرق الإنجليزي Mingana في القرن الماضي، واشتهرت بعنوان “رؤيا ثاوفيلس” وهي قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر، ترويها العذراء مريم شخصياً في رؤيا للبطريرك. ورغم أن النص الوحيد كان بالسريانية، إلا أنه مترجم عن القبطية. ويختتم الراوي حديثه بالتعريف بشخصيته أنه “كيرلس وقد سمعها من فم أبيه البطريرك ثاوفيلس. وتنتهي الدراسة التي جرت على المخطوطة أن كيرلس وثاوفيلس شخصيتان منحولتان في عظة كان يلقيها أسقف قبطي في عيد للعذراء بالعربية، ثم تُرجمت إلى السريانية على يد أحد السريان اليعاقبة المقيمين في مصر.
وتوجد أيضاً مخطوطة إثيوبية من المتحف البريطاني تحكي عظة للبابا ثاوفيلس على طريقة السؤال والجواب ويقدّم البطريرك سؤاله للعذراء فتجيب عليه في رؤيا. هذا النمط الأدبي معروف لدى علماء القبطيات، إذ يستخدمه الوعاظ في الكنائس منتحلين أسماء لشخصيات كنسية عظيمة تضمن لعظاتهم القوة والتأثير المرغوب فيهما.
هذا التنوع الكبير للإنتاج الأدبي، سواء الأصيل أو المنحول يكشف عن المكانة العظيمة التي احتلها هذا البطريرك على مسرح التاريخ الكنسي في القرن الرابع الخامس؛ حتى أنه أثناء وجوده في القسطنطينية عام 394م لتكريس كنيسة الأبوستوليكن apostolikon المقامة على اسمي الرسولين بطرس وبولس، دُعِيَ إلى مجمع لحسم الخلاف بين اثنين من الأساقفة على كرسي بصرى (Bostra) الذي يرأس أسقفيات منطقة العربية، وقدَّم رأيه الذي وافق عليه المجتمعون بلا استثناء وهو : إنه وإن كان يحق لثلاثة أساقفة أن يكرّسوا مطراناً أي رئيس أساقفة أو أسقفاً، إلا أن عزل الأسقف أو المطران لا يكون بواسطة ثلاثة أساقفة بل بواسطة مجمع محلي. هذه المكانة الفائقة لكنيسة الإسكندرية أكدها فيما بعد خليفته القديس كيرلس عمود الدين.
تقييم واقعي لشخصية البابا ثاوفيلس:
تعتبر كنيسة الإسكندرية – وتشاركها كنيسة روما – أن البابا ثاوفيلس من قديسيها الذين تذكر أسماؤهم في مجمع القداس الإلهي متشفعة بصلواتهم، كما تعيد له في 18 بابة من كل عام. بينما المؤرخون المعاصرون يؤاخذونه بسبب موقفه من الأوريجانية ودوره في محاكمة ونفي القديس يوحنا ذهبي الفم أفصح وأحبّ قديسي الكنيسة الشرقية قاطبة والحقيقة أنها قضية واحدة متداخلة، وخفاياها وخلفياتها متشابكة؛ ولابد من التقييم التاريخي الواقعي لرفع اللبس والغموض المحيط بإدخال هذا البطريرك في شركة قديسي الكنيستين الشرقية والغربية معاً. بادئ ذي بدء، جميع المؤاخذات التي قيلت ضد البابا ثاوفيلس صدرت عن أقلام متعاطفة مع القديس يوحنا ذهبي الفم ومتهجمة على البطريرك في عصر هيأت ظروفه السياسية أن يشغل أنبا ثاوفيلس مكانة عليا بسبب ضعف إمبراطور القسطنطينية أركاديوس وحياة البذخ التي كانت تحياها الإمبراطورة أودكسيا؛ إلى جانب حدة ذكاء البطريرك وموهبته في الاستفادة من كل الظروف والإمكانيات المجد الكنيسة. فالتهجم على الشخصيات البارزة بصفة عامة، سمة طبيعية في كل المجتمعات البشرية .
قضية القديس يوحنا ذهبي الفم:
كان من المعروف لدى آباء كنيسة الإسكندرية أن الذين درسوا في مدرسة أنطاكية اللاهوتية، وهي التي تخرج منها ذهبي الفم، ميالون إلى المنطق والعقلانية؛ الأمر الذي تجزع له كنيسة الإسكندرية بسبب بدعة آريوس الذي تتلمذ المؤسس هذه المدرسة اللاهوتية لوسيان الشهيد الأنطاكي. لذلك فإنه وقت ترشيح ذهى الفم لبطريركية القسطنطينية عام 399م، لم يكن لدى أنبا ثاوفيلس أي ضمان لعدم انزلاق أنطاكية ثانية للآريوسية وتفرعاتها العديدة التي تم إخماد أوارها منذ وقت قصير للغاية عقب المجمع المسكوني الثاني عام 381م.
ومخاوف الإسكندرية من اللاهوت الأنطاكي أكدتها الأحداث التالية. فديودورس المعلم اللاهوتي لذهبي الفم، وثيئودورس زميل دراسته والذي صار أسقفاً فيما بعد على المصيصة بآسيا الصغرى، حرمهما مجمع القسطنطينية الثاني عام 499م والذي لم تحضره كنيسة الإسكندرية. الأول بسبب أنه هو معلم نسطور المبتدع والثاني بسبب انحيازه للأوريجانية. ونسطور نفسه، الذي صار بطريركاً على القسطنطينية عام 428م، هو أحد خريجي مدرسة أنطاكية اللاهوتية. لذلك رأى أنبا ثاوفيلس، أقوى شخصيات العصر، أن يختار لكرسي القسطنطينية شخصاً يطمئن إلى إيمانه، وهو إيسيذورس أحد تلاميذ القديس أثناسيوس ورفيق منفاه في تريف. في الوقت الذي رشح فيه فلابيانوس بطريرك أنطاكية كاهنه يوحنا ذهبي الفم. وأرثوذكسية فلابيانوس هذا لم تكن واضحة، إذ انشغل في جمع الأحزاب المتنازعة في بطريركيته وضم الشعب الأنطاكي المبدد. فكان من الطبيعي نشوء معارضة بين الطرفين.
وبدأت القضية تتعقد بدخول عنصر جديد، وهو المجادلات الأوريجانية. فرغم انحصارها في براري نتريا والإسقيط، إلا أن رهبان نتريا لقربهم من الإسكندرية ومدارسها اليونانية، كانوا متعاطفين مع كتابات أوريجانوس ومبادئه ويدرسون في مناهجه بينما رهبان الإسقيط، بسبب بعدهم عن المناطق المأهولة وبساطتهم وسعيهم المستمر وراء القداسة وتفضيلها على الدراسة، ظهرت بينهم بدعة جديدة اشتهرت باسم “أنثروبومورفيزم anthropomorphism أي الصورة الآدمية للأهوت غير المتجسم، وهي مضادة تماماً لمبادئ أوريجانوس وما أعطاه للأهوت والروح من علو وتسام فوق التجسيم والمادة.
وسط هذه المحاذبات، كان الرهبان عوناً للبابا ثاوفيلس في أعماله التعميرية. فكان يستدعيهم لتطهير المعابد الوثنية وتحويلها إلى كنائس. وفي رسالته الفصحية لعام 401م، انتهز الفرصة للرد على بدعة الصورة الآدمية للأهوت غير المتجسم، فاحتج رهبان الإسقيط وطالبوا بتحريم الأوريجانية. وكانت كنيسة روما قد سبقت واتخذت هذا القرار، مما سهل على البابا ثاوفيلس أن ينزل على رغبتهم لأجل سلام الكنيسة. ونظراً للتوافق الكبير بين الإسكندرية وروما، عقد البطريرك مجمعاً محلياً وأعلن هذا الحرم، وإن كنا لا نجد له صدى إلا في الترجمة اللاتينية للقديس جيروم.
وازدادت المشكلة تعقيداً بالتجاء بعض الرهبان المعروفين بـ “الإخوة الطوال” من نتريا إلى القديس يوحنا ذهبي الفم هرباً من البابا ثاوفيلس، وكانوا مشهورين بالتقوى والعلم. فكتب القديس يوحنا ذهبي الفم إلى زميله بطريرك الإسكندرية لمصالحتهم، فلم يلق استجابة. لذلك ترك لهم حرية العبادة والصلاة دون أن يُشركهم معه في الخدمة أو التناول.
وسط هذا الجو المشحون بالتوتر أحست الإمبراطورة مع وصيفاتها من سيدات القصر بالتهجم اللاذع الذي يشنه بطريرك القسطنطينية ضد البذخ والتنعم في القصور. فلجأ الإمبراطور الضعيف أركاديوس إلى البابا ثاوفيلس لعقد مجمع ضد القديس ذهبي الفم. وفعلاً عُقد المجمع في خلقيدونية وحضره 45 أسقفاً منهم 36 أسقفاً مصرياً، وعزلوا ذهبي الفم وحكموا بنفيه.
لكن السماء تدخلت لإنقاذ الكنيسة، سواء كنيسة القسطنطينية أو كنيسة الإسكندرية. فبعد أن صعد القديس يوحنا إلى السفينة التي ستحمله إلى المنفى ودخلت إلى عمق البحار، حدث زلزال هائل رهيب ألقى بالإمبراطورة من فراشها إلى الأرض وهي حامل في ولي العهد، فخافت وارتعبت طالبة سرعة عودة ذهبي الفم في الوقت الذي ارتحت فيه المدينة بالمظاهرات التي تندد بقرار نفي القديس يوحنا ذهبي الفم وهتاف الجماهير بأن الزلزال الذي وقع كان انتقاماً إلهياً منادية بعودة البطريرك إلى كرسيه.
كان البابا ثاوفيلس في القسطنطينية معايناً لهذه الأحداث، فتصالح مع من تبقى من “الإخوة الطوال، ووعى وأدرك الدرس الإلهي الذي من السماء؛ فقفل راجعاً إلى الإسكندرية عام 403م قبل بدء موسم العواصف والنوات.
نهاية حياته:
تشهد التسع سنوات الباقية من حياة البابا ثاوفيلس كيف أنه انتفع روحياً من هذه المحاذبات التي خاضها على المسرح السياسي للأحداث العالمية، وربما يكون هو أول بطريرك على كرسي الإسكندرية حاول الاستفادة بكل الفرص والإمكانيات التي سنحت له. فكانت الدروس التي تلفنها بمثابة حدود إلهية بين السياسة والدين. فقد كرر الإمبراطور الاستعانة به مرة ثانية لعزل ونفي القديس يوحنا ذهبي الفم، وهو النفى الذي قضى فيه نحبه؛ ولكن أنبا ثاوفيلس تجاهل هذه الدعوة، وعاش بقية حياته في توبة وندامة، كما يشهد بذلك كتاب بستان الرهبان، إذ يذكر أنه عند نياحته طوب القديس أرسانيوس لأنه جعل هذه الساعة ساعة الانتقال – أمامه كل حين. وهذا ما جعل سنكسار كنيسة الإسكندرية، ومعها كنيسة روما تتغاضى عن أخطائه وتركز على أعماله الصالحة مثل: التوسع في إنشاء الكنائس والبيع، وميامره ومواعظه الغزيرة؛ فدخل إلى مجمع القديسين.